مسقط في 14
أبريل / العُمانية / يرى الكاتب والناقد المسرحي اليمني هايل المذابي أن الهوية
العُمانية متجذرة في النصوص الأدبية والثقافية منذ أمد بعيد، وهذا ما اشارت إليه
المصادر على سبيل المثال لا الحصر حضورها بكثافة منذ عصر المدارس السعيدية في
النصوص بكل أنواعها، وفي العروض المسرحية على وجه الخصوص، وهي والمواءمة بين
الموروث الشعبي والعناصر الفنية الحديثة شأنٌ عُماني بامتياز.
وفي حديثه
الخاص مع وكالة الأنباء العُمانية، قال الكاتب “المذابي”: “قد
رأينا كيف تحقق ذلك بجمال وإدهاش لا حدود لهما في عرض المخرج المسرحي العماني يوسف
البلوشي، وهو يقدم النص المسرحي “أسطورة شجرة اللبان”، وهو ما نحتاجه اليوم في
سياق المقاومة الثقافية والفنية ضد تمثلات النيو-كولونيالية”.
وفي شأن
الحاجة إلى المسرح اليوم، والتي باتت ضرورة ثقافية واجتماعية حيث تلمّس معالجة
قضايا الواقع المعاش، والأدوات التي يجب أن ينتهجها المسرح كي يستعيد مكانته كمنبر
للتنوير، قال: “المسرح يعد تراثًا لا ماديًا، ووجوده والحاجة إليه لا تنتهي،
ومثلما استطاع المسرح العربي والعُماني أن يثبت وجوده دائمًا من خلال الانتصار
للقيمة الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، فلا شيء يلزمه من الأدوات أكثر من
الحفاظ على مسار الترويج للقيم، وتعزيز حضوره إعلاميًا لاستعادة وزنه وثقله الذي
فقده حين تخلّى عن التغذي على تلك القيم والترويج لها”.
ويشير
الكاتب “المذابي” إلى الطفرات التكنولوجية التي باتت تلامس واقع المسرح
بصورة كبيرة، وتأثير الوسائط الرقمية على تذوق الجمهور المسرحي، والمحفزات التي
يقدمها واقع التكنولوجيا لصالح المسرح، والتحديات التي فرضتها، موضحًا: “لقد
فرضت التكنولوجيا الحديثة تدخل الأتمتة في كافة الصناعات، وتُسمى الصناعات التي
تتدخل فيها التكنولوجيا بالصناعات الصاعدة، وما دونها بالصناعات الهابطة. وأما
تدخلها في الصناعة المسرحية، فيعني استخدام الآلات التي تروّج لطريقة مبتكرة جديدة
لرواية القصص المسرحية. والأتمتة ممارسة جديدة في الصناعة المسرحية، وهي طريقة
جديدة ومثيرة لرواية قصة باستخدام عناصر الآلات والتكنولوجيا التي يمكن أن تغير
فضاء العرض؛ إنها مزيج من التشغيل والإشراف على العناصر الرئيسية للآلة، وكذلك
صيانة الآلات. ويمكن أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في تحريك الكرات الثابتة
والأشخاص، وقدرتها على تغيير المشهد، أمرًا مثيرًا للانتباه، ولا يقل أهمية عن
الإضاءة والصوت. ويمثل استمرار الأتمتة ثورة في المسرح، خصوصًا فيما يخص تقنية كسر
القواعد؛ إنها تمثل دفعة بالمسرح إلى حدود جديدة”.

ويضيف:
“إذا كانت السينوغرافيا في الصناعة المسرحية تعني “الحَيِّز الذي يضم الكتلة
والضوء واللون والفراغ والحركة، وهي العناصر التي تؤثر وتتأثر بالفعل الدرامي الذي
يسهم في صياغة الدلالات المكانية في التشكيل البصري العام”، فإن الملامح الحديثة
لعملية الأتمتة في فضاء العرض المسرحي تشير إلى تأليل أدوات السينوغرافيا بأكملها
وتضيف إليها. ويمكن رصد ملامح متغيرات التكنولوجيا والأتمتة في فضاءات العرض
المسرحي وتحديدها في ثلاثة اتجاهات، وهي: الاتجاه المرئي، والاتجاه السمعي
(الصوت)، والاتجاه الشمي (الرائحة). لقد جعلت التكنولوجيا الحديثة وعملية الأتمتة
من السهل على فضاءات العرض المسرحية ترقية المظهر المرئي لمنتجاتها، وإنجاز مجموعة
متنوعة من المهام؛ من خلال صناعة التكنولوجيا المرتبطة بالسينوغرافيا، ومن خلال
الأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن إنشاء العروض المسرحية بشكل أسرع، وفي نفس
الوقت تحتوي على مزيد من التفاصيل والإثارة، وتجذب المشاهدين بشكل أعمق إلى فضاء
العرض وقصة العرض المسرحي. بالإضافة إلى ذلك، تسمح التكنولوجيا الجديدة للإنتاج
المسرحي بدمج الفيديو والوسائط المتعددة الأخرى في أدائه، سواء كانت خلفيات
الفيديو التي تعزز المجموعة بصور الضباب أو السحب أو المطر، أو مقاطع الفيديو
للمساعدة في عرض الرجل الواحد (المونودراما) “One Man Show” من خلال عرض المقاطع ذات
الصلة. كما أن تقنية الفيديو تضيف بُعدًا إضافيًا وتمنح المصمِّمين المعتمدين
مزيدًا من اللعب أثناء صياغة الإنتاج. ولنتحدث عن الإضاءة، فهي مجال آخر أثرت فيه
التكنولوجيا في سياق التجربة المسرحية وفضاءات العرض، وبالنسبة لكثير من المسارح
التاريخية، فقد تم تشييد فضاءات العرض بدون سقف أو تعتمد على حرائق (شعلات من
النار منتشرة في أرجاء جدران قاعة العرض لتحقيق حالة وجود الضوء في المسرح قبل
اكتشاف الكهرباء، مثلما كان الأمر في المسارح اليونانية). وفي القرن التاسع عشر،
غيّرت الأضواء المسرح، حيث أمكن توجيهها باستخدام العدسات والعاكسات والمرايا؛
واستمر ذلك حتى تم استبدال العدسات والمرايا العاكسة والإضاءة الشمسية في نهاية
المطاف في القرن العشرين بالإضاءة الكهربائية التي استمرت في التطور، وصولًا إلى
أنظمة الإضاءة الحديثة التي نجدها اليوم.
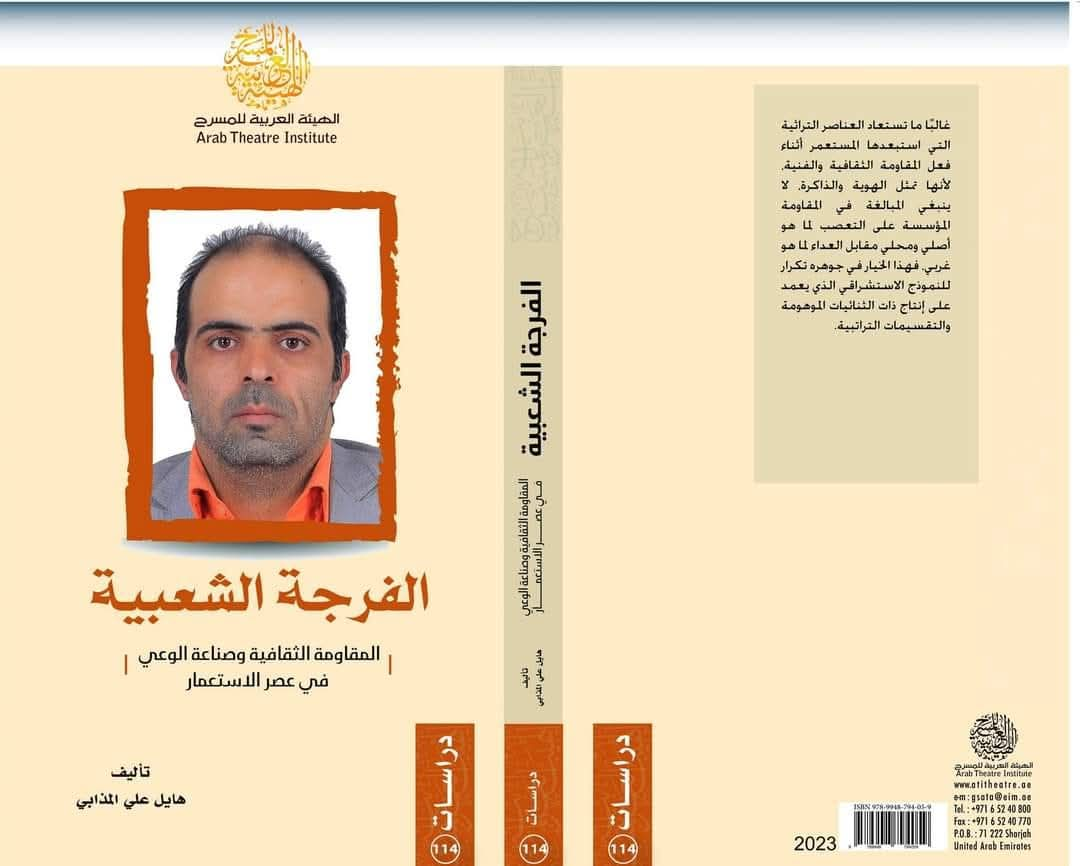
وأشار
“المذابي” إلى الكيفية التي يمكن للمسرح أن يواكب من خلالها العصر
الحالي دون أن يفقد جوهره الفني والإنساني الذي تأسس من أجله، ويقول: من الصحيح
القول إن بقاء كل شيء مرهونٌ بجوهره، أما الشكل فلا يجب الاختلاف عليه أو الفزع من
تغييره، لأن لكل عصر معطيات ثقافية وأدوات جديدة ينبغي مواكبتها والتكيف معها. أي
إن الجوهر هو شرط بقاء وجود المباني والقوالب والأنماط الفنية والثقافية على مر
الدهور بدون اشتراط أي شكليات محددة لها، وخاصية التكيف وقابلية التأقلم تمثل
استعدادًا فطريًا مسبقًا لدى الإنسان، يمنحه القدرة على تقبّل المعطيات الثقافية
الجديدة والمظاهر العصرية الحداثوية والسعي إلى ابتكارها بدون تعصب أو تصلب. وأما
الجوهر، فيمكن التمثيل له بالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، التي يقابلها
في الأعراف الأنثروبولوجية ما نسميه “المعنى أو الجدوى”، وهذا المعنى مرتبط بغرائز
الإنسان وفطرته. وأما قابلية التكيف والتأقلم، فهي شرط بقاء الإنسان على قيد
الحياة، ويمكن رؤيتها بوضوح أثناء تعاقب الفصول الأربعة في السنة وتباين معطيات
المناخ وتقلبه فيها، وهو ذاته ما يُسقَط على المعطيات الثقافية والفنية ومظاهر كل
عصر جديد وأدواته.
ويُوضِّح:
إذا تأملنا حالة المسارح منذ فجر التاريخ، سنجد أنها مختلفة ومتباينة في شكلها،
أما تشابهها، فهو في الجوهر “المعنى والجدوى والقيم الإنسانية والأخلاقية
والاجتماعية”. لذلك يمكن القول: إن معطيات ومظاهر عصرنا اليوم قد تحيل الشكل
المألوف للمسرح إلى شكل آخر تمامًا، والبقاء سيكون للأقدر على التكيف والتأقلم مع
هذه المتغيرات والمعطيات المستحدثة، وإن كان ثمة رهان وإصرار وتعصب، فينبغي أن
يكون في اتجاه الحفاظ على المعنى والجوهر فقط. إن الخوف، كل الخوف، من تسلط
البنيوية الرأسمالية وتوغل مظاهرها في المشهد المسرحي العربي والعالمي.
ولأن الكاتب
اليمني “المذابي” ممارس فاعل في حركة النقد المسرحي، وله إسهامات واضحة في هذا
المجال، فإنه يشير هنا إلى دور التجريد الفني في مواجهة هيمنة المسرح التجاري
والفرجة السطحية، ويتساءل بوضوح عمّا إذا كان الجمهور في المنطقة العربية قد بات
مهيّئًا لتلقي هذا النوع من المسرح “التجريدي”.
ويؤكد: بقدر
ما أتابع العروض المسرحية، أتابع أيضًا أفلامًا سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، منها
القديم ومنها الجديد. وما يدهشني هو قدرات بعض المخرجين على التجريد؛ تجريد معاني
النص إلى إشارات وعلامات وألوان أحيانًا، وأفعال وسلوكيات وزوايا وتقنيات تصوير وإضاءة.
لكنها، رغم ذلك، تُستخدم بترشيد بالغ في كثير من الأعمال الفنية؛ لأنها تتطلب
الموهبة والاحترافية. فالتجريد للمعاني في فن الإخراج أحد أمرين: إما أن تكون
موهوبًا وقادرًا باحترافية عالية على التجريد للمعنى، أو غير موهوب وغير قادر على
التجريد، فتسير في طريق العاديين من المخرجين.
التجريد في
الإخراج الفني هو عملية تحويل الفكرة أو القصة إلى شكل فني مجرد، بعيدًا عن
التفاصيل الحقيقية، ويهدف إلى التركيز على الجوهر والفكرة الرئيسية للقصة، بدلًا
من التفاصيل الثانوية. وكذلك تجسيد العواطف والانفعالات من خلال الأشكال والألوان
والموسيقى، بدلًا من التعبير المباشر. بالإضافة إلى تحفيز خيال الجمهور وتفكيرهم
من خلال تقديم أشكال مجردة ومفتوحة للتفسير، مع القدرة على تجاوز الحدود والقيود
الثابتة للواقع، وتقديم رؤية فنية جديدة ومبتكرة. ويمكن أن تظهر هذه العملية في
الأشكال والمواد المستخدمة في الإخراج، والألوان، والمواد الضوئية، والموسيقى،
والصوت، وكذلك الحركة والرقص.
ويضيف: يقول
الفيلسوف والمسرحي الفرنسي ألبير كامو: “ما يروق لي في المسرح هو أن أرى
الإخراج يعمّق جذوره في الديكور، ومسقطات الأضواء، والستائر الخلفية، والأشياء المرئية
الأخرى. لقد قال بعضهم: إذا أردت أن تتقن إخراج مسرحية، فعليك أن تعرف ثقل
الديكورات بذراعيك. هذه قاعدة فنية عظيمة، وأنا أحب هذه الوظيفة التي تجبرني على
التأمل في سيكولوجية الأشخاص، والتأمل في الوقت نفسه في مكان المصباح أو آنية
الزهر”.
والتجريد
موهبة تتطلب الصبر على التأمل، والقدرة على التركيز، والتفكير العميق، وملاحظة
علاقات الأشياء ببعضها، والمعنى الإجمالي من كل موجود. ولعل المسرح، والحديث هنا
عن مسرحنا العربي الذي نشاهده اليوم، في أمسّ الحاجة لاستيراد مثل هذه التقنيات من
عالم السينما والتلفزيون العالميين، لا لشيء إلا لتطوير المسرح أولًا، وتحديث
آلياته، وزيادة جمالياته.
بمعنى أجمل،
فإن فن التجريد في المسرح يعني “تشييء” الخشبة واستثمار كل محتوياتها، بما فيها كل
مكونات السينوغرافيا، لتجريد معاني العمل المسرحي. إنها موهبة أن تصنع أشياء كثيرة
لقول أشياء كثيرة من أبسط الأشياء وأتفهها وجودًا على الخشبة وفي فضاء العرض.
وربما نجد
لها وجودًا في بعض الأعمال المسرحية العربية، لكنها ضعيفة الحضور ومقتصرة على
اللونيات والإضاءة، بينما هي غائبة تمامًا عن تفاصيل الحركة في سياق العمل
المسرحي.
وإذا كان
هناك عصر لتجريد المعاني يمكن أن نطلق عليه لقب “العصر الذهبي للتجريد”، فهو هذا
العصر الذي نعيشه. ويجب، بالضرورة، أن ينخرط المسرح في التجريد، ويخلع عنه أثوابه
البالية في الإخراج، ويمتح من موارد التجريد قدر ما يستطيع، شأنه في ذلك شأن
السينما والتلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق
بتطوير الذائقة المسرحية لدى الأجيال الجديدة في ظل الفضاءات المفتوحة، يتحدث
“المذابي” عن كيفية تحقيق ذلك، وما يمكن العمل عليه لتسخير النصوص المسرحية
لمواكبة الذائقة العامة، وما يفرضه علينا الواقع:
“مشكلة
الفضاءات المفتوحة في العصر الحالي هي أن التكنولوجيا تفرض على الأجيال الحالية
ثقافة انعزالية أو انطوائية؛ لذلك، تُعد الفضاءات المفتوحة إبحارًا ضد التيار
وتحديًا لعادات التكنولوجيا وتقاليدها. ولنتأمل فقط حال الأطفال والناشئة قبل 20
عامًا وحالهم اليوم؛ فقبل 20 عامًا، كان الآباء والأمهات يستميتون من أجل أن يلزم
أبناؤهم البيوت، أما اليوم فهُم يستميتون في سبيل إقناعهم بالخروج منها! هذه
الثقافة فرضتها التكنولوجيا.
لذلك، إن
كنا سنبحث في تطوير الذائقة أو النصوص المسرحية وتسخيرها للمواكبة، فيجب أن تذهب
الجهود في ذلك المسار الذي يُطوِّع التكنولوجيا وثقافتها من أجل خدمة المسرح، لا
من أجل تحديها أو معاكسة تيارها”.
وفي واقع
أزمة النصوص المسرحية والإخراج والإنتاج المسرحي، يوضح “المذابي” وجهة نظره:
“لا أعتقد أننا نواجه أزمة نصوص مسرحية، ولكن توجد أزمة “دراماتورجيا”، أي ما
يمكن أن نطلق عليه “دراسة التكوين الدرامي وتمثيل العناصر الرئيسية للدراما على
المسرح”، لأن معالجة النصوص المسرحية أهم من القدرة على كتابتها. بالإضافة إلى
ذلك، فإن وجود دراماتورجيين محترفين يسهّل عمل المخرجين كثيرًا، وكذلك عمل
المنتجين، ويسهّل عملية الإنتاج المسرحي عمومًا”.
ويقترب
“المذابي” من مستقبل المسرح في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية الراهنة في
المنطقة العربية، ويؤكد: “سيبقى المسرح، في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية
الراهنة، أو ما سبقها، أو ما سيأتي بعدها في المنطقة العربية، لأن وجوده مرتبط
بوجود صراعات وحاجة المجتمعات إلى القيم والترويج لها. فالصراع ثابت، والقيم
الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية حاجة أزلية مُلحّة. وعليه، فلا يجوز بأي حال من
الأحوال مقارنة المسرح بأي منتج أو قالب فني مستحدث أنتجته التحولات الثقافية
والصناعية مثل السينما ووسائل التكنولوجيا الحديثة؛ لأن هذه القوالب طارئة،
ستمحوها مخرجات التحولات القادمة”.
/ العُمانية
/ النشرة الثقافية / خميس الصلتي






